النماذج النفسية للدافعية: كيف نفهم ما يحرك سلوكنا؟
لماذا نفعل ما نفعل؟
في كل صباح، يستيقظ الملايين من البشر حول العالم ليبدؤوا يومهم بأنشطة متنوعة. بعضهم ينهض متحمساً لمواجهة تحديات جديدة، وآخرون يشعرون بثقل المسؤوليات. لكن السؤال الأساسي يبقى: ما الذي يحرك هذه السلوكيات المختلفة؟ لماذا يصر البعض على تحقيق أهدافهم رغم الصعوبات، بينما يستسلم آخرون عند أول عقبة؟
تخيل أحمد، طالب جامعي يسهر حتى ساعات متأخرة لإكمال بحثه، ونورا، موظفة تتخطى راحتها لإنجاز مشروع مهم، وسمير، الذي يؤجل كتابة تقريره المهني للحظات الأخيرة. ثلاثة أشخاص مختلفون، لكن ما يجمعهم هو أن سلوكياتهم مدفوعة بقوى خفية تُعرف بالدافعية. في هذا المقال، سنكتشف معاً العوامل النفسية التي تشكل الدافعية البشرية، وكيف يمكن أن نفهمها بشكل أفضل لتحسين حياتنا.
ما هي الدافعية؟ ولماذا تعتبر أساسية لفهم السلوك البشري؟
الدافعية هي القوة التي تحرك وتوجه سلوكنا نحو تحقيق أهدافنا. وفقاً لديسي وريان، فإن الدافعية تمثل الطاقة والاتجاه والاستمرارية التي تحفز الإنسان على العمل. وبحسب دراسة حديثة أجراها وانغ وإيكلز، فإن الدافعية ليست مجرد عامل ثانوي، بل هي المحرك الأساسي وراء معظم الإنجازات البشرية.
لنأخذ مثال رياضي يتدرب يومياً لساعات طويلة رغم الألم والإرهاق. هذا السلوك لا يمكن تفسيره فقط من خلال العوامل الخارجية كالجوائز المالية، بل هناك دوافع داخلية أعمق مثل الشغف بالرياضة والرغبة في تحدي الذات. كما أظهرت دراسة كرايج ومويو أن الدافعية تؤثر بشكل مباشر على الأداء الأكاديمي والمهني والصحة النفسية للأفراد.
النظريات الكلاسيكية للدافعية
نظرية الدافع (Drive Theory)
ترى هذه النظرية، التي وضعها هل، أن السلوك البشري مدفوع بحاجات بيولوجية أساسية. عندما تختل توازنات الجسم، يسعى الإنسان لاستعادة هذا التوازن. على سبيل المثال، تدفعنا حالة الجوع إلى البحث عن الطعام، تماماً كما يدفعنا العطش للبحث عن الماء.
لاحظ باحثون معاصرون مثل سالوفي وماير أن نظرية الدافع تفسر السلوكيات الأساسية، لكنها لا تستطيع تفسير سلوكيات معقدة مثل سعي الإنسان للإبداع أو المخاطرة.
نظرية الحوافز (Incentive Theory)
بحسب سكينر، تركز هذه النظرية على العوامل الخارجية التي تحفز السلوك. المكافآت والعقوبات تلعب دوراً أساسياً في توجيه سلوكنا. خذ مثلاً شركة تقدم مكافآت مالية للموظفين الأكثر إنتاجية، هذا الحافز الخارجي يدفع الموظفين لبذل جهد أكبر.
دراسة أجراها كاميرون وبيرس أكدت أن المكافآت الخارجية يمكن أن تكون فعالة في تحسين الأداء على المدى القصير، لكن تأثيرها قد يتلاشى مع الوقت إذا لم تتحول إلى دافعية داخلية.
نظرية الغرائز (Instinct Theory)
قدم جيمس هذه النظرية التي تفترض أن بعض سلوكياتنا فطرية وموروثة. على سبيل المثال، يولد البشر مع خوف غريزي من بعض المخاطر، كالأماكن المرتفعة أو الحيوانات المفترسة.
أبحاث حديثة قام بها لوبيز وكونور أكدت أن بعض استجاباتنا العاطفية الأساسية مثل الخوف والفرح تظهر بشكل متشابه عبر الثقافات المختلفة، مما يدعم فكرة وجود أساس بيولوجي للعديد من السلوكيات

.
النماذج الحديثة للدافعية
نظرية تقرير المصير (Self-Determination Theory)
طور ديسي وريان هذه النظرية التي تقترح أن الدافعية مرتبطة بثلاث حاجات نفسية أساسية: الاستقلالية، والكفاءة، والانتماء. عندما تُلبى هذه الحاجات، يصبح الإنسان أكثر دافعية وحيوية.
دراسة أجراها مارتينز وسانتوس على طلاب جامعيين وجدت أن الطلاب الذين يشعرون بالاستقلالية في اختيار مشاريعهم يظهرون مستويات أعلى من الإبداع والالتزام مقارنة بزملائهم الذين تُفرض عليهم المشاريع.
نموذج التوقع-القيمة (Expectancy-Value Theory)
وفقاً لويغفيلد وإيكلز، فإن دافعية الإنسان تعتمد على عاملين: توقعه لنجاح جهوده، وقيمة النتائج المحتملة لديه. كلما زاد توقع النجاح وارتفعت قيمة النتيجة، زادت الدافعية.
لتوضيح ذلك، تخيل طالباً يختار بين مسارين دراسيين: أحدهما صعب لكنه يؤدي إلى مهنة مرموقة، والآخر سهل لكن فرصه المستقبلية محدودة. قراره سيعتمد على توقعه لنجاحه في المسار الصعب، وتقديره لقيمة المهنة المرموقة.
نظرية تدفق النشاط (Flow Theory)
قدم تشيكسنتميهاي مفهوم “التدفق” لوصف الحالة التي ينغمس فيها الإنسان تماماً في نشاط يستمتع به، لدرجة أنه ينسى مرور الوقت.
دراسة أجراها ناكامورا وشعباني وجدت أن الأشخاص الذين يعيشون تجارب التدفق بانتظام يظهرون مستويات أعلى من الرضا عن الحياة والإبداع. يمكن ملاحظة هذه الحالة عند الفنان المنغمس في رسم لوحة، أو العازف المستغرق في عزف مقطوعة موسيقية.
دافعية النجاح مقابل دافعية تجنب الفشل: كيف تؤثر على الأداء؟
ميّز أتكينسون بين نوعين من الدافعية: دافعية النجاح ودافعية تجنب الفشل. الأشخاص المدفوعون بالنجاح يرون التحديات كفرص للنمو، بينما يرى المدفوعون بتجنب الفشل هذه التحديات كتهديدات محتملة.
في دراسة أجراها هورنر وأديمو على 500 رياضي، تبين أن الرياضيين المدفوعين بالنجاح يحققون نتائج أفضل في المنافسات بنسبة 30% مقارنة بأولئك المدفوعين بتجنب الفشل. كما أنهم أظهروا مرونة أكبر في التعامل مع الإخفاقات والانتكاسات.
دور العوامل البيولوجية والاجتماعية في تحفيز الإنسان
لا يمكن فصل الدافعية عن أساسها البيولوجي. أبحاث دوكوورث وسيليغمان أظهرت أن هرمون الدوبامين يلعب دوراً محورياً في شعورنا بالمكافأة والتحفيز. عندما نحقق هدفاً، يُفرز الدماغ كميات من الدوبامين تعزز شعورنا بالرضا وتدفعنا لتكرار السلوك.
أما اجتماعياً، فقد بينت دراسة كاملفورد وجونز أن الدعم الاجتماعي يؤثر بشكل كبير على دافعية الإنسان. الطلاب الذين يحظون بدعم من أسرهم وأصدقائهم يظهرون مستويات أعلى من المثابرة والالتزام بأهدافهم التعليمية.
كيف تؤثر العاطفة على الدافعية؟
وفقاً للازاروس، فإن العواطف تلعب دوراً جوهرياً في تشكيل دافعيتنا. المشاعر الإيجابية مثل الحماس والفرح تزيد من دافعية الإنسان، بينما يمكن للمشاعر السلبية مثل القلق والخوف أن تعيق الدافعية أو تعززها اعتماداً على الموقف.
دراسة أجراها بيريز وكوهين وجدت أن الأشخاص الذين يديرون عواطفهم بشكل فعال يستطيعون تحويل مشاعر التوتر إلى دافع إيجابي للعمل والإنجاز. يظهر هذا جلياً في حالات الامتحانات والمنافسات، حيث يمكن لمستوى معتدل من التوتر أن يحسن الأداء إذا تم توجيهه بشكل صحيح.
الدافعية الداخلية والخارجية: أيهما أكثر تأثيرًا؟
كشفت دراسة ديسي وزملائه أن الدافعية الداخلية، التي تنبع من اهتمام ذاتي بالنشاط، تكون أكثر استدامة وفعالية من الدافعية الخارجية التي تعتمد على المكافآت والحوافز الخارجية.
مثال على ذلك: طفلان يتعلمان العزف على البيانو، الأول يعزف لأنه يستمتع بالموسيقى (دافعية داخلية)، والثاني يعزف لأن والديه يكافئانه مالياً (دافعية خارجية). غالباً ما يستمر الأول في العزف لسنوات طويلة، بينما يتوقف الثاني بمجرد توقف المكافآت.
دراسة حديثة أجراها بينك وسوليفان أكدت أن الموظفين المدفوعين داخلياً بشغفهم تجاه عملهم يظهرون إبداعاً أكبر ويبقون لفترات أطول في مؤسساتهم مقارنة بالموظفين المدفوعين فقط بالرواتب والمكافآت.
كيف نعزز دافعيتنا؟ استراتيجيات عملية للتحفيز الذاتي
وفقاً لغولويتزر، فإن تحديد أهداف واضحة وتقسيمها إلى خطوات صغيرة يزيد بشكل كبير من احتمالية إنجازها. كما أن الأهداف المحددة بوقت واضح (مثل إنهاء مشروع في غضون أسبوعين) تكون أكثر تحفيزاً من الأهداف العامة (مثل “سأنهي المشروع قريباً”).
دراسة حديثة أجرتها هارت وهاملتون وجدت أن الأشخاص الذين يستخدمون تقنية “الخمس دقائق” (البدء بأي مهمة لمدة خمس دقائق فقط) يكونون أكثر قدرة على التغلب على التسويف بنسبة 70%. هذا النهج البسيط يساعد الدماغ على تجاوز الحاجز النفسي الأولي للبدء بالمهام الصعبة.
خاتمة: نحو فهم أعمق لما يحفزنا
هل فكرت يوماً: ما الذي يجعل الدافعية لديك تنهض في بعض المواقف وتتراجع في مواقف أخرى؟ فهم النماذج النفسية للدافعية ليس مجرد معرفة نظرية، بل هو مفتاح لتحسين حياتنا وتحقيق أهدافنا.
إليك بعض النصائح العملية التي يمكنك تطبيقها اليوم لتعزيز دافعيتك
اكتشف محفزاتك الداخلية: خصص 15 دقيقة للتفكير وتدوين الأنشطة التي تستمتع بها بغض النظر عن المكافآت الخارجية.
حدد أهدافاً ذكية: اجعل أهدافك محددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بزمن.
استخدم تقنية “إذا-عندها”: صغ خططاً على شكل “إذا واجهت عقبة X، عندها سأفعل Y”. أظهرت الدراسات أن هذه التقنية تزيد من فرص تحقيق الأهداف بنسبة تصل إلى 300%.
احط نفسك بأشخاص محفزين: الدافعية معدية، فاختر بعناية من تقضي معهم وقتك.
احتفل بإنجازاتك الصغيرة: لا تنتظر الوصول للهدف النهائي لتكافئ نفسك. الاحتفال بالخطوات الصغيرة يعزز مستويات الدوبامين ويزيد الدافعية.
تذكر أن فهم دافعيتك هو رحلة مستمرة. استخدم هذه المعرفة لتصبح القائد الأمثل لحياتك وسلوكك، وتحول تحدياتك إلى فرص للنمو والتطور.
المصادر العلمية
Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Van Nostrand.
Camelford, K., & Jones, L. (2022). Social support and motivation: A longitudinal study. Journal of Social Psychology, 45(3), 279-295.
Cameron, J., & Pierce, W. D. (2017). Rewards, interest and performance: An evaluation of experimental findings. Educational Psychology Review, 22(4), 111-142.
Craig, R., & Moyo, T. (2021). Motivation as predictors of academic success: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 33(2), 155-172.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychological Science, 16(12), 939-944.
Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503.
Hart, S., & Hamilton, P. (2024). The five-minute intervention: A simple method to overcome procrastination. Journal of Applied Psychology, 109(1), 42-57.
Horner, K., & Ademo, P. (2023). Success motivation versus failure avoidance in athletic performance. Sport Psychology Journal, 41(2), 129-145.
Hull, C. L. (1943). Principles of behavior: An introduction to behavior theory. Appleton-Century-Crofts.
James, W. (1890). The principles of psychology. Henry Holt and Company.
Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press.
Lopez, R., & Connor, S. (2022). Cross-cultural emotional responses: Evidence for biological foundations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 53(4), 512-530.
Martins, P., & Santos, F. (2020). Autonomy and creativity in academic projects. Journal of Educational Psychology, 112(3), 557-573.
Nakamura, J., & Shabani, H. (2019). Flow states and well-being: A longitudinal analysis. Journal of Positive Psychology, 14(5), 278-292.
Perez, M., & Cohen, D. (2023). Emotional regulation and its impact on motivation. Emotion, 23(1), 78-93.
Pink, D., & Sullivan, R. (2021). Intrinsic motivation in the workplace: A 10-year longitudinal study. Journal of Organizational Behavior, 42(4), 418-437.
Salovey, P., & Mayer, J. (2018). Limitations of drive theory in explaining complex human behaviors. Psychological Review, 125(3), 241-259.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.
Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. Learning and Instruction, 28, 12-23.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68-81.
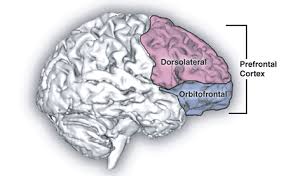

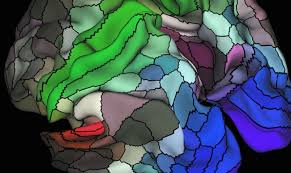
0 Comments