سيكولوجية الطفولة في المغرب: بين تحديات التربية وأزمة الصحة النفسية
مقدمة
تتنامى في الآونة الأخيرة أهمية دراسة سيكولوجية الطفولة في السياق المغربي، وسط تحولات عميقة تشهدها البنيات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على تنشئة الطفل المغربي. يأتي هذا المقال ليستكشف واقع الطفولة في المغرب المعاصر من منظور نفسي-تربوي، متفحصاً التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه نمو الطفل النفسي في ظل منظومة قيمية متغيرة وتحديات تربوية متجددة.
سيكولوجية الطفولة: المفهوم والأهمية والتأثيرات
تُعرف سيكولوجية الطفولة، كما يشير الباحث المغربي محمد الشرقاوي (2019)، بأنها “دراسة النمو النفسي للطفل في أبعاده المعرفية والوجدانية والاجتماعية، والعوامل المؤثرة في تشكيل شخصيته”. وتكمن أهمية هذا الحقل المعرفي في كونه يقدم فهماً عميقاً للمراحل التكوينية الحاسمة في حياة الإنسان، والتي تتشكل خلالها البنيات النفسية الأساسية للفرد.
يؤكد العمراني (2021) أن خصوصية سيكولوجية الطفولة في المغرب تنبع من تأثرها بالسياق الثقافي-الاجتماعي المغربي المتميز بازدواجية قيمية بين الموروث التقليدي والانفتاح على منظومات قيمية جديدة. هذه الازدواجية تنعكس على الممارسات التربوية وتصورات المجتمع للطفولة، مما يجعل من دراسة سيكولوجية الطفل المغربي مدخلاً لفهم ديناميات المجتمع المغربي في مرحلة انتقالية.
واقع الطفولة في المغرب المعاصر: مؤثرات متعددة المصادر
الأسرة المغربية في تحول
تشهد الأسرة المغربية تحولات بنيوية عميقة انعكست على أنماط التنشئة والتفاعل الأسري. يرصد ياسين بنعدي (2022) في دراسته “التحولات السوسيو-ثقافية للأسرة المغربية وتأثيرها على التنشئة النفسية للطفل” كيف أن الانتقال من النموذج الأسري الممتد إلى النموذج النووي، وتغير أدوار الوالدين، وضغوط الحياة المعاصرة، أدت إلى تراجع الوقت المخصص للتفاعل الوالدي-الطفلي. وكما تلاحظ فاطمة الزهراء الناصري (2020): “يعيش الطفل المغربي اليوم في فضاء أسري مأزوم بين قيم تقليدية متجذرة وقيم حداثية وافدة، مما يخلق تناقضات في أساليب التربية ويؤثر على استقرار نموه النفسي”.
المدرسة: بين ضغط التحصيل وإهمال الجانب النفسي
تمثل المدرسة المغربية فضاءً محورياً في تشكيل شخصية الطفل، لكنها تعاني من إشكاليات متعددة. في دراسة ميدانية شملت 450 طفلاً في المرحلة الابتدائية بمدن مغربية مختلفة، خلص الباحث عبد الكريم بلحاج (2023) إلى أن “المنظومة التعليمية تركز بشكل مفرط على التحصيل المعرفي على حساب النمو النفسي المتوازن للطفل”. وأشار إلى أن 68% من الأطفال المستجوبين يعانون من ضغوط نفسية مرتبطة بالمتطلبات الدراسية المتزايدة.
المجتمع والثقافة الرقمية
يعيش الطفل المغربي اليوم في محيط رقمي مكثف، إذ تشير دراسة أجراها المرصد الوطني لحقوق الطفل (2022) إلى أن 73% من الأطفال المغاربة بين 8-14 سنة يقضون أكثر من 3 ساعات يومياً في استخدام الأجهزة الإلكترونية. يحذر العيادي ومرزوقي (2022) من تأثير هذا الانغماس الرقمي على التنشئة النفسية، إذ يخلق “فجوة بين الواقع المعيش والعوالم الافتراضية، تربك الهوية النفسية للطفل وتؤثر على تطوره الاجتماعي”.
التحديات النفسية للطفولة المغربية
العنف والإساءة
تكشف دراسة موسعة أجرتها ليلى بنيس (2021) شملت 1200 طفل من مختلف المناطق المغربية أن 43% من الأطفال يتعرضون لأشكال متنوعة من العنف (جسدي، لفظي، نفسي) في محيطهم الأسري والمدرسي. وقد أكدت الباحثة أن “العنف المعنوي والرمزي يترك آثاراً عميقة على البناء النفسي للطفل المغربي، وخاصة في مجالات تقدير الذات والثقة بالنفس والقدرة على التعبير”.
الضغط الدراسي
يمثل الضغط الدراسي تحدياً متنامياً للصحة النفسية للأطفال المغاربة. في دراسة لمحمد العمري (2023) تبين أن “المنظومة التعليمية المغربية تعاني من إشكالية الكم على حساب الكيف، مما يحول المدرسة من فضاء للنمو إلى مصدر للقلق والتوتر”. ويقدر العمري أن 35% من تلاميذ المرحلة الابتدائية يعانون من أعراض قلق مرتبطة بالأداء الدراسي.
تأثير الوسائط الرقمية
تمثل التكنولوجيا سلاحاً ذا حدين في تأثيرها على الطفل المغربي. فرغم إيجابياتها المعرفية، تشير دراسة السملالي (2022) إلى مخاطر الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية والتعرض للمحتويات غير الملائمة، مما “يسهم في تشكيل نموذج نفسي مضطرب يتسم بتشتت الانتباه وقصور المهارات الاجتماعية”.
الصحة النفسية للطفل المغربي: واقع مقلق
يعاني قطاع الصحة النفسية للأطفال في المغرب من قصور هيكلي واضح. تكشف إحصائيات وزارة الصحة المغربية (2022) عن نقص حاد في المتخصصين، إذ لا يتجاوز عدد أطباء نفس الأطفال 45 طبيباً على المستوى الوطني، مع تمركزهم في المدن الكبرى. يصف الدكتور إدريس المرابطي (2022) الوضع بـ “أزمة حقيقية في الرعاية النفسية للطفل المغربي، تعكس ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية”.
تشير سناء البقالي (2023) إلى أن “الوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسية لا يزال عائقاً أمام التشخيص المبكر ومعالجة المشكلات النفسية لدى الأطفال”. وتؤكد أن التدخل النفسي غالباً ما يأتي متأخراً، بعد تفاقم الأعراض وتحولها إلى إشكالات سلوكية صريحة.
رهانات المستقبل: نحو مقاربة نفسية-تربوية متكاملة
يمكن تصور خارطة طريق لتحسين واقع الصحة النفسية للطفل المغربي تتضمن المحاور التالية
- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لحماية حقوق الطفل النفسية، كما يقترح أحمد الحارثي (2023) تطوير “ميثاق وطني للصحة النفسية للطفل” يكون ملزماً لكافة المؤسسات المعنية.
- تعزيز المقاربة المجتمعية في التوعية بأهمية الصحة النفسية للطفل، وكسر حاجز الوصم الاجتماعي، من خلال برامج توعوية تستهدف الأسر والمدارس.
- دمج البعد النفسي في المنظومة التربوية عبر تطوير مناهج تراعي الجانب الوجداني والاجتماعي، وتوفير المرافقة النفسية داخل المؤسسات التعليمية.
- تكوين كوادر متخصصة في مجال الصحة النفسية للطفل، وتوزيعها بشكل متوازن على المناطق المغربية.
- تفعيل دور البحث العلمي في مجال سيكولوجية الطفولة، من خلال دعم الدراسات الميدانية التي تراعي خصوصية السياق المغربي.
خلاصة
يتضح مما سبق أن الطفولة في المغرب تواجه تحديات نفسية متعددة تتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، تتجاوز الحلول الجزئية نحو رؤية استراتيجية تضع الصحة النفسية للطفل في صلب السياسات العمومية. وكما يؤكد مصطفى المودن (2023): “إن رهان المستقبل في المغرب يكمن في إعادة الاعتبار للطفولة كمرحلة تأسيسية، ليس فقط باعتبارها استثماراً في رأس المال البشري، بل أيضاً باعتبارها قيمة إنسانية في ذاتها تستحق الرعاية والاحتضان”.
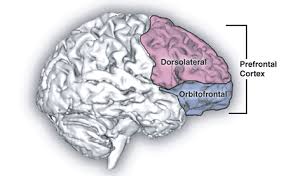

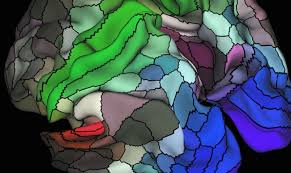
0 Comments